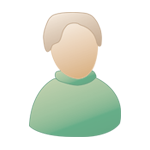[size=18][b][font:b1fe= Arabic Transparent][color:b1fe=green]
دراسة أثرية للمواقع القديمة في منطقتي (قدس-سامع) من المعافر
نسخة للطباعة
الباحث: أ / بشير عبد الرقيب سعيد حميد
الدرجة العلمية: ماجستير
الجامعة: جامعة صنعاء
الكلية: كلية الآداب
القسم: قسم الآثار
بلد الدراسة: اليمن
لغة الدراسة: العربية
تاريخ الإقرار: 2009
نوع الدراسة: رسالة جامعية
ملخص
تناولت هذه الدراسة جزءًا مما كان يسمى قديماً بإقليم المعافر الذي كانت له شهرة واسعة في تاريخ اليمن، وانحصرت في منطقتي قدس وسامع، وذلك من خلال الدراسة الميدانية العلمية الدقيقة عن طريق توثيق وتسجيل ووصف المنطقة المدروسة والآثار المكتشفة، والمعتمدة على التحليل والتفسير والمقارنة. وأسفرت نتائج الدراسة الميدانية عن اكتشاف (21) موقعاً أثرياً في منطقة قدس، وعدد (6) مواقع في منطقة سامع، تعود إلى مراحل ما قبل الإسلام. وتكونت الرسالة من مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة وملاحق مكونة من خرائط وأشكال ولوحات.
أبرزت هذه الدراسة الكثير من النتائج، حيث اتضح أهمية المعافر التاريخية من خلال ذكرها في النقوش اليمنية القديمة التي تحدثت عن مدنها وسكانها منذ حملات المكرب السبئي كرب إيل وتر في القرن السابع قبل الميلاد حتى القرون الميلادية، وأتضح كذلك أن الحدود الجغرافية للمعافر قديماً من خلال تتبع ما ورد في المصادر أن المعافر كان من أكبر أقاليم اليمن قديماَ ويشمل مساحة أكبر مما يسمى اليوم بمحافظة تعز، كما وصل نفوذها إلى الشاطئ الأفريقي.
وفي الجانب الميداني أسفرت أعمال المسح الأثري التي قام بها الباحث عن العديد من النتائج الهامة من خلال ما تم اكتشافه من المواقع الأثرية تعود إلى فترات زمنية مختلفة، تتضمن الكثير من المعالم والشواهد الأثرية والتاريخية التي كشفت النقاب عن صورة متكاملة لمسيرة الحضارة التاريخية ليس لمنطقتي الدراسة فحسب بل للمعافر واليمن بوجه عام.
لقد ظهرت المستوطنات البدائية الأولى بشكل تجمعات سكانية لقرى صغيرة تعود إلى عصور ما قبل التاريخ وبشكل أكبر لفترة العصر البرونزي، تتواجد معظمها على سفوح الجبال المنحدرة، والقيعان المطلة على ضفاف الأودية حيث توفر المياه والنباتات الطبيعية. وبالنسبة لمواقع العصور التاريخية التي تم الكشف عنها، فقد اتضح أن معظمها نشأت على امتداد طريق القوافل القديم. وتشكلت من المدن والقرى الصغيرة والحصون(القلاع)، تحتوي بقاياها على العديد من المنشآت والمباني وملحقاتها من المنشآت المائية والحواجز والبرك والقنوات(السواقي) المائية، وظهرت المنشآت القبورية ذات أشكال متعددة.
وبينت الدراسة أن المواقع المكتشفة أظهرت تنوعاً من حيث فتراتها التاريخية وخصائصها المعمارية والوظيفية، وتتشابه في كثير من خصائصها مع مواقع المدن والمستوطنات الأخرى في اليمن. وكان لارتباط المنطقة واندماجها مع الممالك اليمنية القديمة أثره في إضفاء نفس الروح والهوية اليمنية المشتركة في الثقافة والفكر والدين والذي أنعكس على العمارة والنتاجات الثقافية المادية الأخرى في المواقع المدروسة.
تتناول هذه الدراسة جزءًا مما كان يسمى قديماً بإقليم المعافر وذلك ابتداء بأقدم إشارة في المصادر تدّون وجود المعافر كأرض وقبيلة لعبت دورًا مهماً وأسهمت إسهاماً عظيماً في صياغة التطور الحضاري والتاريخي لليمن القديم، فقد ذكرتها النقوش اليمنية وتحدثت عن مدنها وسكانها منذ حملات المكرب السبئي كرب إيل وتر في القرن السابع قبل الميلاد حتى القرون الميلادية الأولى، كما ذكرت في المصادر الكلاسيكية، واستمر ذكرها في الفترة الإسلامية حيث كان لأهل المعافر دور مشهود في نشر الدعوة الإسلامية وتثبيت أركانها، وما كان لهم من دور فعال في المراحل اللاحقة.
اختار الباحث موضوع هذا البحث لعدة أسباب من أهمها أن تاريخ منطقة المعافر بشكل عام لم يحظ حتى وقتنا الراهن بالدراسة الآثارية المنهجية التي يستحقها، باستثناء الدراسة التي نشرها يوسف محمد عبد الله في مجلة ريدان عام 1988م بعنوان مدينة السوا في كتاب الطواف حول البحر الإرتري، ثم الدراسة الأثرية المنهجية لمدينة السوا التي قام بها عبد الغني علي سعيد عام 1989م، وأعمال المسح الأثري الميداني الذي قامت به البعثة الأمريكية برأسة نورمان والن والذي تركز على الشريط الساحلي للبحر الأحمر حتى باب المندب 1990م، فضلا عن الدراسة التي قام بها كل من سيدوف، و يوسف عبد الله، وعبده عثمان عام 1997م على مجموعة من النقود القتبانية التي تم العثور عليها في مدينة الراهدة.
أما منطقتا الدراسة قدس وسامع من إقليم المعافر قديماً فإنه لم يحدث أن تم فيهما دراسة آثارية منهجية بل ولم يُعنَ بهما أي من الباحثين الآثاريين المحليين أو الأجانب ممن كتبوا عن تاريخ اليمن وحضارته. باستثناء حفرية إنقاذية أجرتها الهيئة العامة للآثار والمتاحف في أحد القبور في موقع الحاز بقدس، والدراسة التي أجراها مهيوب غالب أحمد عن نقش سربيت في سامع، وبعض الزيارات الميدانية الأخرى. وفيما عدا ذلك، فهما لا تزالان كغيرهما من المناطق الأخرى بعيدتين تماماً عن الأعمال والدراسات الأثرية التي أنجزت في مناطق مختلفة من اليمن، مما جعلهما غائبتين عن السجل الأثري وتاريخ البحث العلمي، ولم تدخلا حتى الآن ضمن إستراتيجية الأبحاث الآثارية في اليمن. مع أن أهميتهما التاريخية تتضح جليا من خلال ما نشاهده من الآثار والمخلفات الباقية علي طول وعرض المنطقتين وعلى قمم الجبال وسفوحها، والتي تعكس لنا المستوى الحضاري المتقدم لثقافة هذه المجتمعات، التي هي في حقيقة الأمر جزء لا يتجزأ من ثقافات المجتمع اليمني في العصور التاريخية مع غيرها من المجتمعات الأخرى التي تقع في نطاق المناطق الشرقية والشمالية الشرقية، التي تركزت عليها الدراسات الأثرية من قبل البعثات الأجنبية باعتبارها مراكز أساسية للحضارة اليمنية القديمة، والتي ذكرت بإسهاب في المصادر الكلاسيكية والدينية القديمة التي سجلت التواصل الحضاري بين هذه المناطق ومراكز الحضارة في العالم القديم، وعلى الرغم من أن هذه المصادر الكلاسيكية لم تغفل الحديث عن بعض مدن المعافر، إلا أن الأهمية المرتبطة بالجانب الديني مثلت الدافع القوي لدراسة المناطق الشرقية والشمالية الشرقية دون غيرها.
لذلك فقد جاءت هذه الدراسة في المقام الأول كقاعدة للدراسات التفصيلية وجسراً لخطى الباحثين في حقل الدراسات الأثرية الذين ما زالوا يبحثون عن حلقات التاريخ اليمني المفقود وهم يغضون الطرف عن دراسة المعافر، وفي المقام الثاني تأتي هذه الدراسة لإبراز الهوية التاريخية للمعافر ومساهمة مجتمعاته في التطور الحضاري الذي شهده اليمن قديماً، فضلاً عن تعريف أهل المعافر اليوم بجذورهم التراثية والثقافية، وبهدف تتبع العمق التاريخي للشعوب القديمة التي اتخذت من أرض المعافر مستوطن لها، وما خلفته للأجيال من مظاهر حضارية وعمرانية خالدة، بل وما تخفيه هذه الأرض في جوفها من كنوز دفينة. وذلك استجابة للضرورة الواجبة في الحفاظ على الآثار الباقية، والذي لا نبالغ إذا قلنا إنها تكاد تنتهي بعد أن امتدت إليها عوامل كثيرة لتعمل فيها على الدوام نهباً، وتخريباً في ظل تقصير أحياناً وإهمال من قبل الجهات المختصة التي لم تكلف نفسها حتى توقيف الأيدي اللامسئولة التي تمتد إليها من حين لآخر.
وحين عزم الباحث على إعداد هذه الدراسة - بعد أن نشأت الفكرة مسبقاً- كان لزاماً عليه الدخول من الباب التاريخي، مع المعرفة المسبقة بقلة المصادر والمراجع التاريخية والأثرية عن المعافر عامة، ومنطقتي الدراسة بوجه خاص، نظراً لتركز الأبحاث والدراسات الأثرية في اليمن -حتى الآن- على المناطق التي ذكرت سلفاً، ومع ذلك فقد بحث عن الإشارات القليلة الواردة في المصادر التاريخية عن المعافر، ثم قام الباحث بإجراء أعمال المسح الميداني لمنطقتي قدس وسامع، وفق إمكانياته المحدودة لتحقيق الأهداف المرجوة في توثيق أكبر قدر ممكن من المواقع الأثرية والتاريخية.
وبشكل عام اعتمد البحث على الدراسة الوصفية لكل المواقع الأثرية باستخدام مناهج عدة وفق ما تقتضيه طبيعة الدراسة، فقد تم توثيق ووصف المواقع باستخدام استمارات أعدت لتوثيق المواقع ميدانياً، وتوثيق الملتقطات السطحية بواسطة كروت، وتم أخذ إحداثيات المواقع جغرافياً باستخدام جهاز الملاحة العالمي GPS، وتم استخدام المنهج التاريخي بهدف تتبع المراحل الاستيطانية في المواقع المكتشفة، والمنهج المقارن للمقارنة بين المواقع المكتشفة في المنطقة قيد الدرس مع المواقع الأخرى المدروسة في منطقة المعافر، واليمن بشكل عام.
واعتمد الباحث في تتبع تاريخ المعافر بشكل عام، على المصادر الأساسية والمراجع الأخرى المتمثلة في مجمل الدراسات التي تناولت المعافر، ويمكن تقسيم مادة المصادر على النحو الأتي:
1- النقوش القديمة: وهي النقوش المكتشفة التي ورد فيها ذكر المعافر، والمعروف أنها قليلة مقارنة بالمناطق الأخرى، وتنقسم إلى قسمين:
أ- نقوش ورد فيها ذكر للمعافر ظهرت من أماكن بعيدة عن المعافر كمعبد اوعال صرواح، ومعبد أوام بمارب وهي من المعابد السبئية القديمة الخاصة بالإله المقه، وتوضع فيها تلك النقوش إما تخليداً لذكرى انتصارات عديدة وعظيمة كما في نقش النصر الذي سجل فيه المكرب كرب وتر أحداث حروبه الواسعة من أجل توسيع دولته والقضاء على منافسيه. أو نقوش نذرية مرفقة مع تقديمات نذرية للآلهة عثر عليها في معبد أوام الذي كان مزاراً يحج إليه كل السبئيين، ورغم قلة النقوش التي ورد فيها ذكر المعافر أو بعض مناطقها، إلا أنها تعطي فكرة واضحة نوعا ما عن الأهمية التاريخية للمعافر قديما.
ب- نقوش عثر عليها في بعض مناطق المعافر وهي محدودة العدد نظراً لقصور العملية البحثية، وقد أعطت معلومات مهمة عن المعافر كأرض وقبيلة منها نقش مدينة السوا حاضرة إقليم المعافر قديما، وكذلك نقش سامع.
2- المصادر العربية: وتنقسم أيضاً من خلال موضوعاتها عن المعافر إلى نوعين:
أ- المصادر الجغرافية والبلدانية التي تناولت المعافر في زمن المؤلف وتاريخ المصدر، ويأتي في مقدمتها كتاب صفة جزيرة العرب للسان اليمن أبي محمد الحسن الهمداني المتوفى ما بين350–360هـ، ويعد من أشمل المصادر التي وردت فيه معلومات جغرافيه مفصلة عن المعافر وحدودها الجغرافية، وكتاب أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي المتوفى سنة 375هـ، ومعجم ما استعجم للبكري المتوفى سنة 487هـ، ومعجم البلدان لياقوت الحموي المتوفي 626هـ ومن المصادر التاريخية العربية الإسلامية كتاب المفيد في أخبار صنعاء وزبيد لعمارة اليمني المتوفي سنة 569هـ، وهناك أيضاً صفة بلاد اليمن لأبن المجاور المتوفي سنة 690هـ، والسمط الغالي الثمن لابن حاتم المتوفي 694 هـ، وطرفة الأصحاب للملك الأشرف الرسولي المتوفي 696هـ وتاريخ وصاب للحبيشي (ت: 782هـ) والعقود اللؤلؤية، والعسجد المسبوك للخزرجي المتوفي سنة 812هـ، وكتاب السلوك للجندي المتوفي 730هـ.
ب- مصادر إخبارية تناولت أنساب المعافر وهي كثيرة جداً نورد منها على سبيل المثال كتاب الإكليل للسان اليمن الهمداني، وجمهرة أنساب العرب لابن حزم المتوفى سنة 456هـ.
3- القطع الأثرية المستخرجة من مواقع منطقتي الدراسة، المحفوظة في متحف تعز.
4- مادة إثنوغرافية شفهية سجلت من قبل الباحث أثناء الدراسة الميدانية ساعدت في معرفة الكثير من المواقع الأثرية المندثرة، أو تلك التي حدث فيها أعمال كشف مفاجئ، ولا تحمل على سطحها أي مظاهر أثرية بارزة.
وكان من الطبيعي أن يواجه الباحث مشاكل وصعوبات أثناء عمله المضني منها:
1- شحه المعلومات عن منطقة المعافر عامة ومنطقتي الدراسة قيد البحث بشكل خاص في المصادر والمراجع وتناثر تلك المعلومات هنا وهناك، والكثير منها لا يتعدى مجرد الإشارة العابرة.
2- اختلاف وتشعب بعض الآراء حول الدور التاريخي والاقتصادي وكذا الطبيعة الجغرافية، بل حتى أسماء الأماكن والمآثر فيها.
3- عدم وضوح معظم معالمها التاريخية واندثار ما هو واضح منها نتيجة لعمليات التواصل الاستيطاني وتوسعه.
4- إذا كان للبيئة وعواملها والإنسان وطبيعته قديماً دورٌ كبير في صياغة وصنع كل الانجازات الحضارية لليمن القديم، فقد كان لهما حديثاً بالغ الأثر في طمس تلك الانجازات، وقد ظهر ذلك واضحاً أثناء الدراسة الميدانية للمواقع المكتشفة.
ومع ذلك فقد تمكن الباحث من تكوين صورة يرى أنها واضحة وواقعية عن آثار المنطقة بحالتها الراهنة، وذلك من خلال الدراسة الميدانية التي قام بها وفق إمكانياته المحدودة، لتحقيق الأهداف المرجوة في البحث عن المواقع الأثرية. كما تمكن من تحديد معظم المواقع، ومعرفة ما تحتويه من بقايا أطلال لمعالم ظاهرة أو مندثرة أو مطمورة تحت الأرض، ظهرت بعض مخلفاتها من خلال أعمال الكشف المفاجئ.
وبناء على ما توفر للباحث من مادة تاريخية وأثرية فقد تكونت هذه الدراسة من مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة وملاحق مكونة من خرائط وأشكال ولوحات:
الفصل الأول: الموقع الجغرافي والتركيب الجيولوجي والتسمية. وينقسم إلى مبحثين:
المبحث الأول: الموقع الجغرافي والتركيب الجيولوجي: وفيه جاء تحديد الجغرافية المكانية للحدود التي كانت عليها أرض المعافر قديماً، وتفصيل كل الآراء التي حددت المعافر مكانياً من خلال المصادر العربية الإسلامية كالكتب الجغرافية والبلدانية وغيرها، ابتداء بأقدم ذكرٍ لحدودها الجغرافية القديمة، وصولاً إلى تحديد ما يعرف اليوم أرض الحجرية، كون الجزء الرئيسي من هذه الدراسة يقع ضمن نطاقها الجغرافي، وبما تزودنا به الدراسات الجغرافية الطبوغرافية والجيولوجية الحديثة.
المبحث الثاني: التسمية ومدلولها اللغوي والاصطلاحي: و فيه تم تناول تسمية المعافر ومنطقتي الدراسة. وما أورده المؤرخون والباحثون عن نسب المعافر في المصادر اللغوية والتاريخية والجغرافية.
الفصل الثاني: أهمية المعافر في حضارة اليمن، وينقسم كذلك إلى مبحثين:
المبحث الأول: المعافر في المصادر النقشية والكلاسيكية: و فيه قدم الباحث دراسة عن أهمية المعافر في حضارة اليمن القديم قبل الإسلام من خلال المعلومات التي وردت في المصادر النقشية والكلاسيكية.
المبحث الثاني: تحدث فيه عن دور المعافر في العصر الإسلامي مراعيا التسلسل الزمني للأحداث، والدور الفعّال الذي لعبه أهل المعافر في الفتوحات الإسلامية وفي نشر الدعوة الإسلامية وتثبيت أركان الدين الحنيف. بالإضافة إلى ما أوردته المصادر التاريخية من ذكر لمناطق الدراسة.
الفصل الثالث: دراسة المواقع الأثرية القديمة في منطقتي قدس وسامع، وفيه دراسة للمواقع المكتشفة في منطقتي الدراسة وينقسم إلى مبحثين:
المبحث الأول: المواقع الأثرية في منطقة قدس
المبحث الثاني: المواقع الأثرية في منطقة سامع
الـخــاتمة:
أبرزت الدراسة كثير من النتائج تتعلق بعضها بالجانب الجغرافي والتاريخي للمعافر، والبعض الآخر بالدراسة الميدانية، حيث اتضح من المعلومات التي وردت في المصادر التاريخية العربية والإسلامية، والدراسات الحديثة أن المعافر كان من أكبر أقاليم اليمن قديماً، يضم مساحة أكبر مما يسمى اليوم بمحافظة تعز، إذ كان يمتد ليشمل بعض مناطق من محافظة إب . وليس ذلك فحسب بل أن المعافر امتدت في فترات سابقة إلى أشاعر تهامة استناداً إلى نقش السوا الذي ورد فيه (ضبأت/ أشعرين) أي جند الأشاعر، وربما جاء ذلك حصيلة توسع نفوذ حاكم المعافر في الحكم وبحسب الظروف السياسية للدولة المركزية التي ينضوي تحت سلطتها حاكم المعافر، كما وصل نفوذها إلى الشاطئ الأفريقي - المناطق التي تقع على الساحل المقابل لليمن- وذلك استناداً إلى المعلومات التي وردت في كتاب الطواف.
كما تـأتي أهمية المعافر التاريخية من خلال ذكرها في المصادر النقشية والكلاسيكية القديمة منذ الألف الأول قبل الميلاد. إذ أتضح من المعلومات التي أوردها نقش النصر أن المعافر كانت تشكل أهمية سياسية واقتصادية وتجارية نتيجة لموقعها الإستراتيجي بإشرافها على الشريط الساحلي للبحر الأحمر حتى باب المندب غرباً، وتبرز تلك الأهمية من كونها أولى المناطق التي هاجمها المكرب كرب إيل وتر قبل غيرها.
ونلمس أهمية المعافر السياسية من خلال علاقاتها مع الممالك اليمنية القديمة حيث أصبحت أوسان مملكة قوية بعلاقتها التجارية مع المعافر وشكلت خطراً لمصالح سبأ بعد احتكارها التجارة البحرية في السلع الأفريقية، والسيطرة على الساحل اليمنى الأفريقي. وعندما تعرضت أوسان لحرب قوية من سبأ وبمساعدة قتبان وحضرموت المتحالفتان معها، أضفيت أرضيها إلى نفوذ دولة قتبان مكافئة لها على وقوفها في الحرب مع سبأ. ولم يلبث أن تجدد النزاع مرة أخرى بين سبأ وقتبان عندما سيطرت الأخيرة على المعافر وما عليها من الموانئ، بعد أن أصبح لها نفوذ قوي.
وكان لعلاقة المعافر بالكيان الريداني دوراً في اختفاء مملكة قتبان وخروجها من دائرة المنافسة بعد أن بسط الريدانين نفوذهم على تجارة الركن الجنوبي الغربي المتصل ببلاد الزنج، ليتضح أن المعافر كانت سبباً رئيسياً في ازدهار الكيان الريداني على حساب مملكتي سبأ وحضرموت، على أنها لم تلبث أن أثرت سلباَ على حمير في القرن الثالث الميلادي عند تعرضها لهجمات عديدة من قبل الأحباش انطلاقاً من أرض المعافر.
وفي الفترة الإسلامية لم تتراجع أهمية المعافر حيث كانت ما تزال تحتل أهمية بالغة برزت من خلال رسالتين للرسول صلى الله عليه وسلم إلى أقيال اليمن، ومنهم النعمان قيل المعافر، وقد أشاد الرسول r بإسلامهم، وكان للمعافر وأهلها دوراً مشهوداً في نشر الدعوة الإسلامية وتثبيت دعائم أركانها، وخصوصاً في فتح مصر.
ويتضح أيضاً أن المعافر بعد فترة الخلافة الراشدة كان قد شملها حكم الدولة الإسلامية الكبرى القائمة في المدينة ثم دمشق ثم بغداد، كما شمل غيرها من أقسام اليمن، كما شملها حكم الممالك المحلية التي استقلت عن نطاق الخلافة.
وتخبرنا المصادر التاريخية عن الصناعات الحرفية التي اشتهرت بها مناطق عديدة في المعافر مثل سلوق، وشرعب، ومهرة بصناعة الثياب والرماح المعافرية، واستمرت كذلك حتى الفترة الإسلامية، وليس ذلك فحسب بل كان لأهل المعافر نشاط معروف وملموس بالتجارة الداخلية والخارجية وحب المغامرة لمزاولة الاتجار.
وفي الجانب الميداني أسفرت أعمال المسح الأثري عن العديد من النتائج الهامة من خلال ما تم اكتشافه من المواقع الأثرية تعود إلى مراحل وفترات زمنية مختلفة، وتضمنت تلك المواقع بمختلف مكوناتها وأشكالها على العديد من المعالم والشواهد الأثرية والتاريخية التي كشفت النقاب عن صورة متكاملة لمسيرة الحضارة التاريخية ليس لمنطقتي الدراسة فحسب بل للمعافر واليمن بوجه عام، منذ المراحل البدائية الأولى للإنسان القديم التي اتسمت بعدم الاستقرار حتى وصوله إلى المراحل الاستيطانية المتطورة المتميزة بالاستقرار والإبداع في كافة نواحي الحياة.
لقد ظهرت المستوطنات البدائية الأولى بشكل تجمعات سكانية لقرى صغيرة تعود إلى عصور ما قبل التاريخ وبشكل أكبر لفترة العصر البرونزي، حيث تواجد معظمها على سفوح الجبال المنحدرة، والقيعان المطلة على ضفاف الأودية ذات الينابيع الجارية والنباتات الطبيعية، وقد احتوت معظم هذه المستوطنات على بقايا أساسات لمنشآت سكنية دائرية وبيضاوية ومربعة بعضها مستقلة (فردية) كما هو الحال في موقع حليم والهجمة، الحَنْحَن ، وقحفة الصرم في منطقة قدس وموقع حرور بمنطقة سامع.
وتواجدت مواقع المستوطنات الجماعية بشكل مباني سكنية تحوي إلى جانب تلك الأنماط السابقة أنماط أخرى مستطيلة ومربعة، تشتمل على أكثر من غرفة يصل متوسط مساحتها بين 3- 4م، شيدت بالأحجار المتوفرة في الموقع نفسه، واستخدمت مباشرة دون إجراء أي تشذيب فيها، وتظهر أساساتها الباقية بشكل صفوف أحادية بعضها وضعت مباشرة على الأرض، والبعض الأخر بداخل خنادق صغيرة، كما زود بعضها بأسوار حجرية لا تزال بقاياها ماثلة للعيان في بعض الجهات كما هو واضح في موقع قحفة الدمنة، وموقع نجد معادن.
أما بالنسبة لمواقع العصور التاريخية التي تم الكشف عنها فقد اتضح أن معظمها نشأت على الطريق التجاري القديم، الذي كان مستخدماً من قبل القوافل القادمة من ميناء عدن، والمتجهة إلى المراكز والحواضر التجارية القديمة في الأجزاء الغربية والجنوبية الغربية من المعافر- وعلى وجه الخصوص - السوا، وجبأ مدينتي المعافر القديمة. وكذلك هو الحال في العديد من المدن والمستوطنات الأخرى في اليمن التي ارتبط نشوئها بالطرق قديماً، كما أن الطرق قد عرجت في حالات عديدة ببعض المستوطنات لتلبي حاجيات سالكيها الأمنية والغذائية.
وكشفت الدراسة أيضاً أن الطريق التجاري القديم قد عرج في أغلب الحالات على الوديان حيث العيون والينابيع الجارية، وذلك من مميزات نشوء المستوطنات والمدن في اليمن قديماً. حيث أن أنسب طريق للقوافل هو ذلك الذي يمر على الوديان لتلبية احتياجات القوافل بالمياه الضرورية. وتبين كذلك من خلال أعمال المسح على الطريق وبقايا امتداده على نقيلي بسيط والجواجب أنه أتخذ مسارين ضمن حدود منطقة الدراسة التابعة لقدس اليوم من الجهة الشرقية بعد أن كان على مسار واحد من منطقة المفاليس، ويبدو أن ذلك حدث على مراحل زمنية.
وقد وجدت المدن والقرى الصغيرة المتنوعة بشكل أطلال متهدمة، تحتوي بقاياها على العديد من المنشآت المعمارية والمائية وملحقاتها (كالحواجز، والبرك، والقنوات) التي تتشابه في كثير من خصائصها المعمارية والوظيفية مع المدن والمستوطنات الأخرى التي تعود إلى الفترة التاريخية في مناطق المرتفعات اليمنية، وقد استخدمت في بنائها الأحجار المهندمة بمقاسات منتظمة، وبنيت الأسوار التحصينية على المدن كما هو واضح على موقع مدينة حرب بالأسلوب المتعارف عليه في المدن اليمنية الأخرى، بالأحجار الكبيرة المهندمة وبطريقة الجداران المزدوجة وبينهما أحجار الدبش الصغيرة، ولم يعرف ما إذا كان السور قد زود بالأبراج الدفاعية كمدينة السوا مثلاً، نظراً لتهدم أجزاء كبيرة منه.
كما كشف المسح الأثري عن المنشآت القبورية بأشكال متعددة لمجموعات فردية وجماعية، منها القبور الكهفية التي ظهرت على نوعين قبور كهفية طبيعية على واجهات المنحدرات الصخرية ذات حماية طبيعية تم إحاطتها بجدران حجرية في الأجزاء المكشوفة منها كما هو الحال في مقابر موقعي حليم والهجمة، وقبور صخرية نحتها الإنسان أو تدخل في تغير ملامحها، كما ظهر واضحاً في مقابر مواقع حمدان، الحاز، يدى، نجد معادن، وهناك أيضاً القبور الأرضية التي حفرت في التربة الطينية وهي كثيرة ضمن المواقع المدروسة وجد نماذج منها في مواقع، حرب، الكدرة، البطنة، الذخف من منطقة قدس ومقابر موقعي الخنف، وصيرة من منطقة سامع، ومعظم هذه المقابر تعرضت لأعمال الكشف المفاجئ، ومنها جاء أغلب الأثاث الجنائزي المدروس هنا. وتجدر الإشارة إلى أن القبور التي اشتملت على أثاث جنائزي تنوع من مقبرة لأخرى من حيث المواد الخام والشكل والوظيفة، مما يكشف عن الرقي الحضاري والتقني، ويعكس في نفس الوقت المستوى الاجتماعي ومدى التطور الفكري والعقائدي الذي وصل إليه الإنسان القديم ضمن منطقتي الدراسة، ومن جانب آخر جاء أنواع من الأثاث متشابهاً مع أثاث القبوريات الأخرى في اليمن، وتحديداً مع المواقع اليمنية في الهضبة والساحل الجنوبي والمنطقة الشرقية، ويعود إلى فترات مختلفة، مما يدل على حجم التواصل الثقافي الكبير بين هذه المجتمعات مع المجتمعات اليمنية الأخرى المحيطة بها. كما جاء منه ما يدل على التواصل الخارجي مع الحضارات الأخرى.
وكشفت نتائج الدراسة الميدانية عن العديد من المنشآت المائية منها ما استخدم لغرض الشرب، ووجدت بالقرب من المستوطنات السكنية كما هو واضح في عين ذي مسينح التي حفرت على الصخر بجانب مستوطنة دار السادة، أو بالقرب من الينابيع الجارية في الوديان مثل مستوطنة الهجمة وقحفة الدمنة وفي العادة تم حفر برك (مآجل) متنوعة لتجميع مياه الأمطار وخزنها حتى مواسم الجفاف، مثلما هو حاصل في مستوطنة حرور.
وبالنسبة لأعمال الري فقد أتضح أن السكان القدماء في منطقتي الدراسة اعتمدوا على الزراعة بدرجة كبيرة في الحصول على الغذاء- إلى جانب الحرف والمهارات اليدوية الأخرى التي كانوا يمارسونها كنشاطات اقتصادية إنتاجية- ولذلك الغرض استخدمت الحواجز التحويلية التقليدية في المراحل المبكرة من الاستيطان في بعض المواقع المكتشفة التي شيدت على روافد الوديان مثلما هو واضح في وادي شريع بسامع، وكذلك الآبار وملحقاتها من القنوات (السواقي) الرئيسية والفرعية وبرك التجميع والتوزيع بأشكال متعددة، حيث ظهرت الآبار بإشكال دائرية وطويت بالأحجار من الداخل، وأتضح أنها هي الأخرى استخدمت في عملية ري الأراضي الزراعية، ومن نماذجها بئر ذي الجمال من قدس، وبئرين من سامع هما النقوع والسبيل وهي تتشابه مع المنشآت المائية في الكثير من المناطق اليمنية الأخرى.
وكان من ضمن المعالم الأثرية القديمة التي تعود إلى فترة ما قبل الإسلام الحصون(القلاع) التي تم الكشف عنها في منطقتي الدراسة كما هو الحال في الحصون مثل مطران، الشوار في قدس وحصن سامع، ظهرت جميعها متشابهة من حيث الخصائص المعمارية الباقية فيها وخصوصاً تلك المتعلقة بالطرق الصاعدة المؤدية إليها وما عليها من المنشآت المائية، حيث تكشف تلك الطرق من خلال وقوعها في الجهة الغربية عن أغراض دفاعية مشتركة أو ما شابه ذلك، كما أن المنشآت المائية التي وجدت فيها جاءت متشابهة من حيث الشكل والنوع والوظيفة، فقد أتضح أنها حفرت في الصخر، وكان لا بد وأن يتضمن الحصن من كريف كبير يأخذ في الغالب الشكل الدائري تتفاوت قطرها من حصن لأخر، طويت من الداخل بالأحجار والقضاض ويلحق به عدد من الأحواض الصغيرة الدائرية الشكل تصل عددها في بعض الحصون إلى ستة أحواض تتراوح متوسط أقطارها ما بين 2.5م إلى 3م، كسيت من الداخل بالقضاض. وليس ذلك فحسب بل أتضح أن جميعها اتخذت مواقع إستراتيجية من قمم الجبال المرتفعة التي شيدت عليها، على أن القمة الجبلية التي يقع فيها بقايا حصن سامع تعتبر هي الأعلى فيما بينها حيث بلغ الارتفاع فيها 2660م عن سطح البحر، ويعد ثاني أعلى ارتفاع في منطقة المعافر بعد جبل صبر، مما يؤكد ذلك على أهمية الحصن القديمة ليس فحسب لمنطقة سامع ولكن لجزء واسع من المعافر، كونه كان يقع بالقرب من مدينتي جبأ والسوا، وكذلك الحال بالنسبة لحصون منطقتي الدراسة خاصة واليمن عموماً يلاحظ أن نشؤوها أرتبط بالمدن وخصوصاً تلك التي قامت كمحطات تجارية على الطرق التجارية القديمة، حيث شكلت من خلال مواقعها تلك حصوناً منيعة لهذا الغرض وأغراض أخرى عديدة.
[/color][/font][/b][/size]
دراسة أثرية للمواقع القديمة في منطقتي (قدس-سامع) من المعافر
نسخة للطباعة
الباحث: أ / بشير عبد الرقيب سعيد حميد
الدرجة العلمية: ماجستير
الجامعة: جامعة صنعاء
الكلية: كلية الآداب
القسم: قسم الآثار
بلد الدراسة: اليمن
لغة الدراسة: العربية
تاريخ الإقرار: 2009
نوع الدراسة: رسالة جامعية
ملخص
تناولت هذه الدراسة جزءًا مما كان يسمى قديماً بإقليم المعافر الذي كانت له شهرة واسعة في تاريخ اليمن، وانحصرت في منطقتي قدس وسامع، وذلك من خلال الدراسة الميدانية العلمية الدقيقة عن طريق توثيق وتسجيل ووصف المنطقة المدروسة والآثار المكتشفة، والمعتمدة على التحليل والتفسير والمقارنة. وأسفرت نتائج الدراسة الميدانية عن اكتشاف (21) موقعاً أثرياً في منطقة قدس، وعدد (6) مواقع في منطقة سامع، تعود إلى مراحل ما قبل الإسلام. وتكونت الرسالة من مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة وملاحق مكونة من خرائط وأشكال ولوحات.
أبرزت هذه الدراسة الكثير من النتائج، حيث اتضح أهمية المعافر التاريخية من خلال ذكرها في النقوش اليمنية القديمة التي تحدثت عن مدنها وسكانها منذ حملات المكرب السبئي كرب إيل وتر في القرن السابع قبل الميلاد حتى القرون الميلادية، وأتضح كذلك أن الحدود الجغرافية للمعافر قديماً من خلال تتبع ما ورد في المصادر أن المعافر كان من أكبر أقاليم اليمن قديماَ ويشمل مساحة أكبر مما يسمى اليوم بمحافظة تعز، كما وصل نفوذها إلى الشاطئ الأفريقي.
وفي الجانب الميداني أسفرت أعمال المسح الأثري التي قام بها الباحث عن العديد من النتائج الهامة من خلال ما تم اكتشافه من المواقع الأثرية تعود إلى فترات زمنية مختلفة، تتضمن الكثير من المعالم والشواهد الأثرية والتاريخية التي كشفت النقاب عن صورة متكاملة لمسيرة الحضارة التاريخية ليس لمنطقتي الدراسة فحسب بل للمعافر واليمن بوجه عام.
لقد ظهرت المستوطنات البدائية الأولى بشكل تجمعات سكانية لقرى صغيرة تعود إلى عصور ما قبل التاريخ وبشكل أكبر لفترة العصر البرونزي، تتواجد معظمها على سفوح الجبال المنحدرة، والقيعان المطلة على ضفاف الأودية حيث توفر المياه والنباتات الطبيعية. وبالنسبة لمواقع العصور التاريخية التي تم الكشف عنها، فقد اتضح أن معظمها نشأت على امتداد طريق القوافل القديم. وتشكلت من المدن والقرى الصغيرة والحصون(القلاع)، تحتوي بقاياها على العديد من المنشآت والمباني وملحقاتها من المنشآت المائية والحواجز والبرك والقنوات(السواقي) المائية، وظهرت المنشآت القبورية ذات أشكال متعددة.
وبينت الدراسة أن المواقع المكتشفة أظهرت تنوعاً من حيث فتراتها التاريخية وخصائصها المعمارية والوظيفية، وتتشابه في كثير من خصائصها مع مواقع المدن والمستوطنات الأخرى في اليمن. وكان لارتباط المنطقة واندماجها مع الممالك اليمنية القديمة أثره في إضفاء نفس الروح والهوية اليمنية المشتركة في الثقافة والفكر والدين والذي أنعكس على العمارة والنتاجات الثقافية المادية الأخرى في المواقع المدروسة.
تتناول هذه الدراسة جزءًا مما كان يسمى قديماً بإقليم المعافر وذلك ابتداء بأقدم إشارة في المصادر تدّون وجود المعافر كأرض وقبيلة لعبت دورًا مهماً وأسهمت إسهاماً عظيماً في صياغة التطور الحضاري والتاريخي لليمن القديم، فقد ذكرتها النقوش اليمنية وتحدثت عن مدنها وسكانها منذ حملات المكرب السبئي كرب إيل وتر في القرن السابع قبل الميلاد حتى القرون الميلادية الأولى، كما ذكرت في المصادر الكلاسيكية، واستمر ذكرها في الفترة الإسلامية حيث كان لأهل المعافر دور مشهود في نشر الدعوة الإسلامية وتثبيت أركانها، وما كان لهم من دور فعال في المراحل اللاحقة.
اختار الباحث موضوع هذا البحث لعدة أسباب من أهمها أن تاريخ منطقة المعافر بشكل عام لم يحظ حتى وقتنا الراهن بالدراسة الآثارية المنهجية التي يستحقها، باستثناء الدراسة التي نشرها يوسف محمد عبد الله في مجلة ريدان عام 1988م بعنوان مدينة السوا في كتاب الطواف حول البحر الإرتري، ثم الدراسة الأثرية المنهجية لمدينة السوا التي قام بها عبد الغني علي سعيد عام 1989م، وأعمال المسح الأثري الميداني الذي قامت به البعثة الأمريكية برأسة نورمان والن والذي تركز على الشريط الساحلي للبحر الأحمر حتى باب المندب 1990م، فضلا عن الدراسة التي قام بها كل من سيدوف، و يوسف عبد الله، وعبده عثمان عام 1997م على مجموعة من النقود القتبانية التي تم العثور عليها في مدينة الراهدة.
أما منطقتا الدراسة قدس وسامع من إقليم المعافر قديماً فإنه لم يحدث أن تم فيهما دراسة آثارية منهجية بل ولم يُعنَ بهما أي من الباحثين الآثاريين المحليين أو الأجانب ممن كتبوا عن تاريخ اليمن وحضارته. باستثناء حفرية إنقاذية أجرتها الهيئة العامة للآثار والمتاحف في أحد القبور في موقع الحاز بقدس، والدراسة التي أجراها مهيوب غالب أحمد عن نقش سربيت في سامع، وبعض الزيارات الميدانية الأخرى. وفيما عدا ذلك، فهما لا تزالان كغيرهما من المناطق الأخرى بعيدتين تماماً عن الأعمال والدراسات الأثرية التي أنجزت في مناطق مختلفة من اليمن، مما جعلهما غائبتين عن السجل الأثري وتاريخ البحث العلمي، ولم تدخلا حتى الآن ضمن إستراتيجية الأبحاث الآثارية في اليمن. مع أن أهميتهما التاريخية تتضح جليا من خلال ما نشاهده من الآثار والمخلفات الباقية علي طول وعرض المنطقتين وعلى قمم الجبال وسفوحها، والتي تعكس لنا المستوى الحضاري المتقدم لثقافة هذه المجتمعات، التي هي في حقيقة الأمر جزء لا يتجزأ من ثقافات المجتمع اليمني في العصور التاريخية مع غيرها من المجتمعات الأخرى التي تقع في نطاق المناطق الشرقية والشمالية الشرقية، التي تركزت عليها الدراسات الأثرية من قبل البعثات الأجنبية باعتبارها مراكز أساسية للحضارة اليمنية القديمة، والتي ذكرت بإسهاب في المصادر الكلاسيكية والدينية القديمة التي سجلت التواصل الحضاري بين هذه المناطق ومراكز الحضارة في العالم القديم، وعلى الرغم من أن هذه المصادر الكلاسيكية لم تغفل الحديث عن بعض مدن المعافر، إلا أن الأهمية المرتبطة بالجانب الديني مثلت الدافع القوي لدراسة المناطق الشرقية والشمالية الشرقية دون غيرها.
لذلك فقد جاءت هذه الدراسة في المقام الأول كقاعدة للدراسات التفصيلية وجسراً لخطى الباحثين في حقل الدراسات الأثرية الذين ما زالوا يبحثون عن حلقات التاريخ اليمني المفقود وهم يغضون الطرف عن دراسة المعافر، وفي المقام الثاني تأتي هذه الدراسة لإبراز الهوية التاريخية للمعافر ومساهمة مجتمعاته في التطور الحضاري الذي شهده اليمن قديماً، فضلاً عن تعريف أهل المعافر اليوم بجذورهم التراثية والثقافية، وبهدف تتبع العمق التاريخي للشعوب القديمة التي اتخذت من أرض المعافر مستوطن لها، وما خلفته للأجيال من مظاهر حضارية وعمرانية خالدة، بل وما تخفيه هذه الأرض في جوفها من كنوز دفينة. وذلك استجابة للضرورة الواجبة في الحفاظ على الآثار الباقية، والذي لا نبالغ إذا قلنا إنها تكاد تنتهي بعد أن امتدت إليها عوامل كثيرة لتعمل فيها على الدوام نهباً، وتخريباً في ظل تقصير أحياناً وإهمال من قبل الجهات المختصة التي لم تكلف نفسها حتى توقيف الأيدي اللامسئولة التي تمتد إليها من حين لآخر.
وحين عزم الباحث على إعداد هذه الدراسة - بعد أن نشأت الفكرة مسبقاً- كان لزاماً عليه الدخول من الباب التاريخي، مع المعرفة المسبقة بقلة المصادر والمراجع التاريخية والأثرية عن المعافر عامة، ومنطقتي الدراسة بوجه خاص، نظراً لتركز الأبحاث والدراسات الأثرية في اليمن -حتى الآن- على المناطق التي ذكرت سلفاً، ومع ذلك فقد بحث عن الإشارات القليلة الواردة في المصادر التاريخية عن المعافر، ثم قام الباحث بإجراء أعمال المسح الميداني لمنطقتي قدس وسامع، وفق إمكانياته المحدودة لتحقيق الأهداف المرجوة في توثيق أكبر قدر ممكن من المواقع الأثرية والتاريخية.
وبشكل عام اعتمد البحث على الدراسة الوصفية لكل المواقع الأثرية باستخدام مناهج عدة وفق ما تقتضيه طبيعة الدراسة، فقد تم توثيق ووصف المواقع باستخدام استمارات أعدت لتوثيق المواقع ميدانياً، وتوثيق الملتقطات السطحية بواسطة كروت، وتم أخذ إحداثيات المواقع جغرافياً باستخدام جهاز الملاحة العالمي GPS، وتم استخدام المنهج التاريخي بهدف تتبع المراحل الاستيطانية في المواقع المكتشفة، والمنهج المقارن للمقارنة بين المواقع المكتشفة في المنطقة قيد الدرس مع المواقع الأخرى المدروسة في منطقة المعافر، واليمن بشكل عام.
واعتمد الباحث في تتبع تاريخ المعافر بشكل عام، على المصادر الأساسية والمراجع الأخرى المتمثلة في مجمل الدراسات التي تناولت المعافر، ويمكن تقسيم مادة المصادر على النحو الأتي:
1- النقوش القديمة: وهي النقوش المكتشفة التي ورد فيها ذكر المعافر، والمعروف أنها قليلة مقارنة بالمناطق الأخرى، وتنقسم إلى قسمين:
أ- نقوش ورد فيها ذكر للمعافر ظهرت من أماكن بعيدة عن المعافر كمعبد اوعال صرواح، ومعبد أوام بمارب وهي من المعابد السبئية القديمة الخاصة بالإله المقه، وتوضع فيها تلك النقوش إما تخليداً لذكرى انتصارات عديدة وعظيمة كما في نقش النصر الذي سجل فيه المكرب كرب وتر أحداث حروبه الواسعة من أجل توسيع دولته والقضاء على منافسيه. أو نقوش نذرية مرفقة مع تقديمات نذرية للآلهة عثر عليها في معبد أوام الذي كان مزاراً يحج إليه كل السبئيين، ورغم قلة النقوش التي ورد فيها ذكر المعافر أو بعض مناطقها، إلا أنها تعطي فكرة واضحة نوعا ما عن الأهمية التاريخية للمعافر قديما.
ب- نقوش عثر عليها في بعض مناطق المعافر وهي محدودة العدد نظراً لقصور العملية البحثية، وقد أعطت معلومات مهمة عن المعافر كأرض وقبيلة منها نقش مدينة السوا حاضرة إقليم المعافر قديما، وكذلك نقش سامع.
2- المصادر العربية: وتنقسم أيضاً من خلال موضوعاتها عن المعافر إلى نوعين:
أ- المصادر الجغرافية والبلدانية التي تناولت المعافر في زمن المؤلف وتاريخ المصدر، ويأتي في مقدمتها كتاب صفة جزيرة العرب للسان اليمن أبي محمد الحسن الهمداني المتوفى ما بين350–360هـ، ويعد من أشمل المصادر التي وردت فيه معلومات جغرافيه مفصلة عن المعافر وحدودها الجغرافية، وكتاب أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي المتوفى سنة 375هـ، ومعجم ما استعجم للبكري المتوفى سنة 487هـ، ومعجم البلدان لياقوت الحموي المتوفي 626هـ ومن المصادر التاريخية العربية الإسلامية كتاب المفيد في أخبار صنعاء وزبيد لعمارة اليمني المتوفي سنة 569هـ، وهناك أيضاً صفة بلاد اليمن لأبن المجاور المتوفي سنة 690هـ، والسمط الغالي الثمن لابن حاتم المتوفي 694 هـ، وطرفة الأصحاب للملك الأشرف الرسولي المتوفي 696هـ وتاريخ وصاب للحبيشي (ت: 782هـ) والعقود اللؤلؤية، والعسجد المسبوك للخزرجي المتوفي سنة 812هـ، وكتاب السلوك للجندي المتوفي 730هـ.
ب- مصادر إخبارية تناولت أنساب المعافر وهي كثيرة جداً نورد منها على سبيل المثال كتاب الإكليل للسان اليمن الهمداني، وجمهرة أنساب العرب لابن حزم المتوفى سنة 456هـ.
3- القطع الأثرية المستخرجة من مواقع منطقتي الدراسة، المحفوظة في متحف تعز.
4- مادة إثنوغرافية شفهية سجلت من قبل الباحث أثناء الدراسة الميدانية ساعدت في معرفة الكثير من المواقع الأثرية المندثرة، أو تلك التي حدث فيها أعمال كشف مفاجئ، ولا تحمل على سطحها أي مظاهر أثرية بارزة.
وكان من الطبيعي أن يواجه الباحث مشاكل وصعوبات أثناء عمله المضني منها:
1- شحه المعلومات عن منطقة المعافر عامة ومنطقتي الدراسة قيد البحث بشكل خاص في المصادر والمراجع وتناثر تلك المعلومات هنا وهناك، والكثير منها لا يتعدى مجرد الإشارة العابرة.
2- اختلاف وتشعب بعض الآراء حول الدور التاريخي والاقتصادي وكذا الطبيعة الجغرافية، بل حتى أسماء الأماكن والمآثر فيها.
3- عدم وضوح معظم معالمها التاريخية واندثار ما هو واضح منها نتيجة لعمليات التواصل الاستيطاني وتوسعه.
4- إذا كان للبيئة وعواملها والإنسان وطبيعته قديماً دورٌ كبير في صياغة وصنع كل الانجازات الحضارية لليمن القديم، فقد كان لهما حديثاً بالغ الأثر في طمس تلك الانجازات، وقد ظهر ذلك واضحاً أثناء الدراسة الميدانية للمواقع المكتشفة.
ومع ذلك فقد تمكن الباحث من تكوين صورة يرى أنها واضحة وواقعية عن آثار المنطقة بحالتها الراهنة، وذلك من خلال الدراسة الميدانية التي قام بها وفق إمكانياته المحدودة، لتحقيق الأهداف المرجوة في البحث عن المواقع الأثرية. كما تمكن من تحديد معظم المواقع، ومعرفة ما تحتويه من بقايا أطلال لمعالم ظاهرة أو مندثرة أو مطمورة تحت الأرض، ظهرت بعض مخلفاتها من خلال أعمال الكشف المفاجئ.
وبناء على ما توفر للباحث من مادة تاريخية وأثرية فقد تكونت هذه الدراسة من مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة وملاحق مكونة من خرائط وأشكال ولوحات:
الفصل الأول: الموقع الجغرافي والتركيب الجيولوجي والتسمية. وينقسم إلى مبحثين:
المبحث الأول: الموقع الجغرافي والتركيب الجيولوجي: وفيه جاء تحديد الجغرافية المكانية للحدود التي كانت عليها أرض المعافر قديماً، وتفصيل كل الآراء التي حددت المعافر مكانياً من خلال المصادر العربية الإسلامية كالكتب الجغرافية والبلدانية وغيرها، ابتداء بأقدم ذكرٍ لحدودها الجغرافية القديمة، وصولاً إلى تحديد ما يعرف اليوم أرض الحجرية، كون الجزء الرئيسي من هذه الدراسة يقع ضمن نطاقها الجغرافي، وبما تزودنا به الدراسات الجغرافية الطبوغرافية والجيولوجية الحديثة.
المبحث الثاني: التسمية ومدلولها اللغوي والاصطلاحي: و فيه تم تناول تسمية المعافر ومنطقتي الدراسة. وما أورده المؤرخون والباحثون عن نسب المعافر في المصادر اللغوية والتاريخية والجغرافية.
الفصل الثاني: أهمية المعافر في حضارة اليمن، وينقسم كذلك إلى مبحثين:
المبحث الأول: المعافر في المصادر النقشية والكلاسيكية: و فيه قدم الباحث دراسة عن أهمية المعافر في حضارة اليمن القديم قبل الإسلام من خلال المعلومات التي وردت في المصادر النقشية والكلاسيكية.
المبحث الثاني: تحدث فيه عن دور المعافر في العصر الإسلامي مراعيا التسلسل الزمني للأحداث، والدور الفعّال الذي لعبه أهل المعافر في الفتوحات الإسلامية وفي نشر الدعوة الإسلامية وتثبيت أركان الدين الحنيف. بالإضافة إلى ما أوردته المصادر التاريخية من ذكر لمناطق الدراسة.
الفصل الثالث: دراسة المواقع الأثرية القديمة في منطقتي قدس وسامع، وفيه دراسة للمواقع المكتشفة في منطقتي الدراسة وينقسم إلى مبحثين:
المبحث الأول: المواقع الأثرية في منطقة قدس
المبحث الثاني: المواقع الأثرية في منطقة سامع
الـخــاتمة:
أبرزت الدراسة كثير من النتائج تتعلق بعضها بالجانب الجغرافي والتاريخي للمعافر، والبعض الآخر بالدراسة الميدانية، حيث اتضح من المعلومات التي وردت في المصادر التاريخية العربية والإسلامية، والدراسات الحديثة أن المعافر كان من أكبر أقاليم اليمن قديماً، يضم مساحة أكبر مما يسمى اليوم بمحافظة تعز، إذ كان يمتد ليشمل بعض مناطق من محافظة إب . وليس ذلك فحسب بل أن المعافر امتدت في فترات سابقة إلى أشاعر تهامة استناداً إلى نقش السوا الذي ورد فيه (ضبأت/ أشعرين) أي جند الأشاعر، وربما جاء ذلك حصيلة توسع نفوذ حاكم المعافر في الحكم وبحسب الظروف السياسية للدولة المركزية التي ينضوي تحت سلطتها حاكم المعافر، كما وصل نفوذها إلى الشاطئ الأفريقي - المناطق التي تقع على الساحل المقابل لليمن- وذلك استناداً إلى المعلومات التي وردت في كتاب الطواف.
كما تـأتي أهمية المعافر التاريخية من خلال ذكرها في المصادر النقشية والكلاسيكية القديمة منذ الألف الأول قبل الميلاد. إذ أتضح من المعلومات التي أوردها نقش النصر أن المعافر كانت تشكل أهمية سياسية واقتصادية وتجارية نتيجة لموقعها الإستراتيجي بإشرافها على الشريط الساحلي للبحر الأحمر حتى باب المندب غرباً، وتبرز تلك الأهمية من كونها أولى المناطق التي هاجمها المكرب كرب إيل وتر قبل غيرها.
ونلمس أهمية المعافر السياسية من خلال علاقاتها مع الممالك اليمنية القديمة حيث أصبحت أوسان مملكة قوية بعلاقتها التجارية مع المعافر وشكلت خطراً لمصالح سبأ بعد احتكارها التجارة البحرية في السلع الأفريقية، والسيطرة على الساحل اليمنى الأفريقي. وعندما تعرضت أوسان لحرب قوية من سبأ وبمساعدة قتبان وحضرموت المتحالفتان معها، أضفيت أرضيها إلى نفوذ دولة قتبان مكافئة لها على وقوفها في الحرب مع سبأ. ولم يلبث أن تجدد النزاع مرة أخرى بين سبأ وقتبان عندما سيطرت الأخيرة على المعافر وما عليها من الموانئ، بعد أن أصبح لها نفوذ قوي.
وكان لعلاقة المعافر بالكيان الريداني دوراً في اختفاء مملكة قتبان وخروجها من دائرة المنافسة بعد أن بسط الريدانين نفوذهم على تجارة الركن الجنوبي الغربي المتصل ببلاد الزنج، ليتضح أن المعافر كانت سبباً رئيسياً في ازدهار الكيان الريداني على حساب مملكتي سبأ وحضرموت، على أنها لم تلبث أن أثرت سلباَ على حمير في القرن الثالث الميلادي عند تعرضها لهجمات عديدة من قبل الأحباش انطلاقاً من أرض المعافر.
وفي الفترة الإسلامية لم تتراجع أهمية المعافر حيث كانت ما تزال تحتل أهمية بالغة برزت من خلال رسالتين للرسول صلى الله عليه وسلم إلى أقيال اليمن، ومنهم النعمان قيل المعافر، وقد أشاد الرسول r بإسلامهم، وكان للمعافر وأهلها دوراً مشهوداً في نشر الدعوة الإسلامية وتثبيت دعائم أركانها، وخصوصاً في فتح مصر.
ويتضح أيضاً أن المعافر بعد فترة الخلافة الراشدة كان قد شملها حكم الدولة الإسلامية الكبرى القائمة في المدينة ثم دمشق ثم بغداد، كما شمل غيرها من أقسام اليمن، كما شملها حكم الممالك المحلية التي استقلت عن نطاق الخلافة.
وتخبرنا المصادر التاريخية عن الصناعات الحرفية التي اشتهرت بها مناطق عديدة في المعافر مثل سلوق، وشرعب، ومهرة بصناعة الثياب والرماح المعافرية، واستمرت كذلك حتى الفترة الإسلامية، وليس ذلك فحسب بل كان لأهل المعافر نشاط معروف وملموس بالتجارة الداخلية والخارجية وحب المغامرة لمزاولة الاتجار.
وفي الجانب الميداني أسفرت أعمال المسح الأثري عن العديد من النتائج الهامة من خلال ما تم اكتشافه من المواقع الأثرية تعود إلى مراحل وفترات زمنية مختلفة، وتضمنت تلك المواقع بمختلف مكوناتها وأشكالها على العديد من المعالم والشواهد الأثرية والتاريخية التي كشفت النقاب عن صورة متكاملة لمسيرة الحضارة التاريخية ليس لمنطقتي الدراسة فحسب بل للمعافر واليمن بوجه عام، منذ المراحل البدائية الأولى للإنسان القديم التي اتسمت بعدم الاستقرار حتى وصوله إلى المراحل الاستيطانية المتطورة المتميزة بالاستقرار والإبداع في كافة نواحي الحياة.
لقد ظهرت المستوطنات البدائية الأولى بشكل تجمعات سكانية لقرى صغيرة تعود إلى عصور ما قبل التاريخ وبشكل أكبر لفترة العصر البرونزي، حيث تواجد معظمها على سفوح الجبال المنحدرة، والقيعان المطلة على ضفاف الأودية ذات الينابيع الجارية والنباتات الطبيعية، وقد احتوت معظم هذه المستوطنات على بقايا أساسات لمنشآت سكنية دائرية وبيضاوية ومربعة بعضها مستقلة (فردية) كما هو الحال في موقع حليم والهجمة، الحَنْحَن ، وقحفة الصرم في منطقة قدس وموقع حرور بمنطقة سامع.
وتواجدت مواقع المستوطنات الجماعية بشكل مباني سكنية تحوي إلى جانب تلك الأنماط السابقة أنماط أخرى مستطيلة ومربعة، تشتمل على أكثر من غرفة يصل متوسط مساحتها بين 3- 4م، شيدت بالأحجار المتوفرة في الموقع نفسه، واستخدمت مباشرة دون إجراء أي تشذيب فيها، وتظهر أساساتها الباقية بشكل صفوف أحادية بعضها وضعت مباشرة على الأرض، والبعض الأخر بداخل خنادق صغيرة، كما زود بعضها بأسوار حجرية لا تزال بقاياها ماثلة للعيان في بعض الجهات كما هو واضح في موقع قحفة الدمنة، وموقع نجد معادن.
أما بالنسبة لمواقع العصور التاريخية التي تم الكشف عنها فقد اتضح أن معظمها نشأت على الطريق التجاري القديم، الذي كان مستخدماً من قبل القوافل القادمة من ميناء عدن، والمتجهة إلى المراكز والحواضر التجارية القديمة في الأجزاء الغربية والجنوبية الغربية من المعافر- وعلى وجه الخصوص - السوا، وجبأ مدينتي المعافر القديمة. وكذلك هو الحال في العديد من المدن والمستوطنات الأخرى في اليمن التي ارتبط نشوئها بالطرق قديماً، كما أن الطرق قد عرجت في حالات عديدة ببعض المستوطنات لتلبي حاجيات سالكيها الأمنية والغذائية.
وكشفت الدراسة أيضاً أن الطريق التجاري القديم قد عرج في أغلب الحالات على الوديان حيث العيون والينابيع الجارية، وذلك من مميزات نشوء المستوطنات والمدن في اليمن قديماً. حيث أن أنسب طريق للقوافل هو ذلك الذي يمر على الوديان لتلبية احتياجات القوافل بالمياه الضرورية. وتبين كذلك من خلال أعمال المسح على الطريق وبقايا امتداده على نقيلي بسيط والجواجب أنه أتخذ مسارين ضمن حدود منطقة الدراسة التابعة لقدس اليوم من الجهة الشرقية بعد أن كان على مسار واحد من منطقة المفاليس، ويبدو أن ذلك حدث على مراحل زمنية.
وقد وجدت المدن والقرى الصغيرة المتنوعة بشكل أطلال متهدمة، تحتوي بقاياها على العديد من المنشآت المعمارية والمائية وملحقاتها (كالحواجز، والبرك، والقنوات) التي تتشابه في كثير من خصائصها المعمارية والوظيفية مع المدن والمستوطنات الأخرى التي تعود إلى الفترة التاريخية في مناطق المرتفعات اليمنية، وقد استخدمت في بنائها الأحجار المهندمة بمقاسات منتظمة، وبنيت الأسوار التحصينية على المدن كما هو واضح على موقع مدينة حرب بالأسلوب المتعارف عليه في المدن اليمنية الأخرى، بالأحجار الكبيرة المهندمة وبطريقة الجداران المزدوجة وبينهما أحجار الدبش الصغيرة، ولم يعرف ما إذا كان السور قد زود بالأبراج الدفاعية كمدينة السوا مثلاً، نظراً لتهدم أجزاء كبيرة منه.
كما كشف المسح الأثري عن المنشآت القبورية بأشكال متعددة لمجموعات فردية وجماعية، منها القبور الكهفية التي ظهرت على نوعين قبور كهفية طبيعية على واجهات المنحدرات الصخرية ذات حماية طبيعية تم إحاطتها بجدران حجرية في الأجزاء المكشوفة منها كما هو الحال في مقابر موقعي حليم والهجمة، وقبور صخرية نحتها الإنسان أو تدخل في تغير ملامحها، كما ظهر واضحاً في مقابر مواقع حمدان، الحاز، يدى، نجد معادن، وهناك أيضاً القبور الأرضية التي حفرت في التربة الطينية وهي كثيرة ضمن المواقع المدروسة وجد نماذج منها في مواقع، حرب، الكدرة، البطنة، الذخف من منطقة قدس ومقابر موقعي الخنف، وصيرة من منطقة سامع، ومعظم هذه المقابر تعرضت لأعمال الكشف المفاجئ، ومنها جاء أغلب الأثاث الجنائزي المدروس هنا. وتجدر الإشارة إلى أن القبور التي اشتملت على أثاث جنائزي تنوع من مقبرة لأخرى من حيث المواد الخام والشكل والوظيفة، مما يكشف عن الرقي الحضاري والتقني، ويعكس في نفس الوقت المستوى الاجتماعي ومدى التطور الفكري والعقائدي الذي وصل إليه الإنسان القديم ضمن منطقتي الدراسة، ومن جانب آخر جاء أنواع من الأثاث متشابهاً مع أثاث القبوريات الأخرى في اليمن، وتحديداً مع المواقع اليمنية في الهضبة والساحل الجنوبي والمنطقة الشرقية، ويعود إلى فترات مختلفة، مما يدل على حجم التواصل الثقافي الكبير بين هذه المجتمعات مع المجتمعات اليمنية الأخرى المحيطة بها. كما جاء منه ما يدل على التواصل الخارجي مع الحضارات الأخرى.
وكشفت نتائج الدراسة الميدانية عن العديد من المنشآت المائية منها ما استخدم لغرض الشرب، ووجدت بالقرب من المستوطنات السكنية كما هو واضح في عين ذي مسينح التي حفرت على الصخر بجانب مستوطنة دار السادة، أو بالقرب من الينابيع الجارية في الوديان مثل مستوطنة الهجمة وقحفة الدمنة وفي العادة تم حفر برك (مآجل) متنوعة لتجميع مياه الأمطار وخزنها حتى مواسم الجفاف، مثلما هو حاصل في مستوطنة حرور.
وبالنسبة لأعمال الري فقد أتضح أن السكان القدماء في منطقتي الدراسة اعتمدوا على الزراعة بدرجة كبيرة في الحصول على الغذاء- إلى جانب الحرف والمهارات اليدوية الأخرى التي كانوا يمارسونها كنشاطات اقتصادية إنتاجية- ولذلك الغرض استخدمت الحواجز التحويلية التقليدية في المراحل المبكرة من الاستيطان في بعض المواقع المكتشفة التي شيدت على روافد الوديان مثلما هو واضح في وادي شريع بسامع، وكذلك الآبار وملحقاتها من القنوات (السواقي) الرئيسية والفرعية وبرك التجميع والتوزيع بأشكال متعددة، حيث ظهرت الآبار بإشكال دائرية وطويت بالأحجار من الداخل، وأتضح أنها هي الأخرى استخدمت في عملية ري الأراضي الزراعية، ومن نماذجها بئر ذي الجمال من قدس، وبئرين من سامع هما النقوع والسبيل وهي تتشابه مع المنشآت المائية في الكثير من المناطق اليمنية الأخرى.
وكان من ضمن المعالم الأثرية القديمة التي تعود إلى فترة ما قبل الإسلام الحصون(القلاع) التي تم الكشف عنها في منطقتي الدراسة كما هو الحال في الحصون مثل مطران، الشوار في قدس وحصن سامع، ظهرت جميعها متشابهة من حيث الخصائص المعمارية الباقية فيها وخصوصاً تلك المتعلقة بالطرق الصاعدة المؤدية إليها وما عليها من المنشآت المائية، حيث تكشف تلك الطرق من خلال وقوعها في الجهة الغربية عن أغراض دفاعية مشتركة أو ما شابه ذلك، كما أن المنشآت المائية التي وجدت فيها جاءت متشابهة من حيث الشكل والنوع والوظيفة، فقد أتضح أنها حفرت في الصخر، وكان لا بد وأن يتضمن الحصن من كريف كبير يأخذ في الغالب الشكل الدائري تتفاوت قطرها من حصن لأخر، طويت من الداخل بالأحجار والقضاض ويلحق به عدد من الأحواض الصغيرة الدائرية الشكل تصل عددها في بعض الحصون إلى ستة أحواض تتراوح متوسط أقطارها ما بين 2.5م إلى 3م، كسيت من الداخل بالقضاض. وليس ذلك فحسب بل أتضح أن جميعها اتخذت مواقع إستراتيجية من قمم الجبال المرتفعة التي شيدت عليها، على أن القمة الجبلية التي يقع فيها بقايا حصن سامع تعتبر هي الأعلى فيما بينها حيث بلغ الارتفاع فيها 2660م عن سطح البحر، ويعد ثاني أعلى ارتفاع في منطقة المعافر بعد جبل صبر، مما يؤكد ذلك على أهمية الحصن القديمة ليس فحسب لمنطقة سامع ولكن لجزء واسع من المعافر، كونه كان يقع بالقرب من مدينتي جبأ والسوا، وكذلك الحال بالنسبة لحصون منطقتي الدراسة خاصة واليمن عموماً يلاحظ أن نشؤوها أرتبط بالمدن وخصوصاً تلك التي قامت كمحطات تجارية على الطرق التجارية القديمة، حيث شكلت من خلال مواقعها تلك حصوناً منيعة لهذا الغرض وأغراض أخرى عديدة.
[/color][/font][/b][/size]